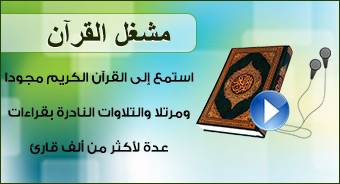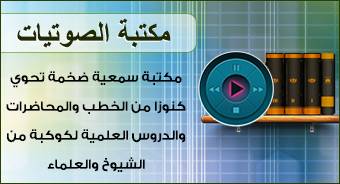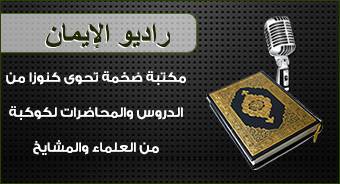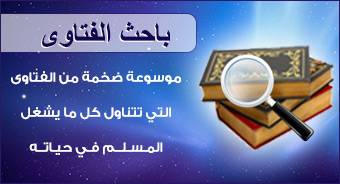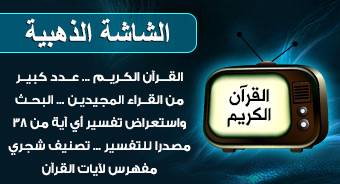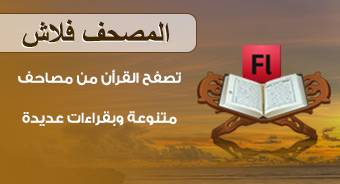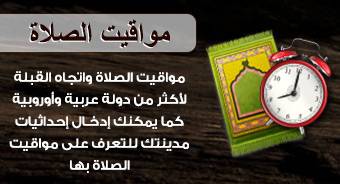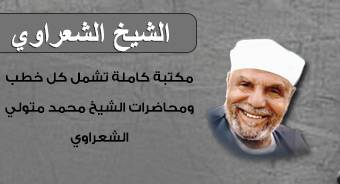|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المتواري على أبواب البخاري
وفيه أنس: قال حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً. وعامة خمرنا البسر والتمر. وفيه ابن عمر: قال قام عمر على المنبر فقال: أما بعد! نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر ما خامر العقل. قلت: رضي الله عنك! غرضها الردّ على الكوفيين إذ فرّقوا بين ماء العنب وغيره. فلم يحّرموا من غيره إلا القدر المسكر خاصة، وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة.
قلت: رضي الله عنك! الحديث مطابق للترجمة إلا قوله: ويسمّيه بغير اسمه وإن كان قد ورد مبيّناً في غير هذا الطريق. ولكنه لما لم يوافق شرط البخاري تلك الزيادة ترجم عليها وقنع من الاستدلال عليها بقوله: «من أمتي» فإنّ كونهم من الأمّة يبعد معه أن يستحلونها بغير تأويل ولا تحريف. فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة إذ تحريم الخمر معلوم ضرورة. فهذا هو سرّ مطابقة الترجمة لهذه الزيادة. والله أعلم.
وفيه جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. وفيه أبو قتادة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وترجم لحديث أنس- باب خدمة الصغار الكبار-. قلت: رضي الله عنك! وهم الشارح البخاري في قوله: «إذا كان مسكراً» وقال: إن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر به. ولا يلزم البخاري ذلك. إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار. وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول- أعنى حديث أنس- ولا شك أن الذي كان يسقيه للقوم حينئذ مسكر. ولهذا دخل عندهم في عموم التحريم للخمر. وقال أنس: وإنا لنعدّها يومئذ الخمر دلّ على أنه مسكر. وأما قوله: «لا يجعل إدامين في إدام» فيطابق حديث جابر وأبي قتادة ويكون النهي معلّلاً بعلل مستقلة. إما تحقق إسكار الكثير. وإما يوقع الإسكار بالاختلاط سريعاً. وإما الإسراف والشدة. والتعليل بالإسراف مبيّن في حديث النهي عن قران التمر هذا. والتمرتان نوع واحد فكيف بالمتعدد.
فيه أبو هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بقدح لبن وقدح خمر. وفيه أم الفضل: شكّ الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بقدح لبن فشرب. وفيه جابر: جاء أبو حميد بقدح فيه لبن من النقيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا خمرته، ولو أن تعرض عليه عودًا». وفيه البراء: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وأبو بكر معه. قال أبو بكر: مررنا براعٍ- وقد عطش النبي صلى الله عليه وسلم فحلبت كثبة من لبن في قدح. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. الحديث. وفيه أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم الصدقة اللقحة الصغيّ منحةً، والشاة الصفيّ منحة تغدو بإناء وتروح بآخر». وفيه ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض ومضمضنا. وفيه أنس: قال، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: «رفعت إلى السدرة المنتهى». فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران، ونهران باطنان. فأما الظاهران فالنيل والفرات. وأما الباطنان فنهران في الجنّة. وأتيت بثلاث أقداح قدح فيه لبن. وقدح فيه خمر، وقدح فيه عسل. فأخذت الذي فيه اللبن فشربت. فقيل لي: أصبت الفطرة، أنت وأمتك. قلت: رضي الله عنك! أطال في هذه الترجمة النفس، ليردّ قول من تخيّل أن اللبن يسكر كثيره. فردّ هذا الفقه البعيد بالنص. ثم هو غير مستقيم لأن اللبن بمجرّده لا يسكر مطلقاً. وإنما يتفق ذلك نادراً لصفة تحدث عليه.
قلت: رضي الله عنك! إن التماس الماء العذب الطيّب دون غيره ليس منافياً في الزهد، ولا داخلاً في الترفّه والترف المكروه، بخلاف تطييب الماء بالمسك وماء الورد وغيره فهو مكروه عند مالك. وقد نصّ على كراهة الماء المطيّب بالكافور للمحرم والحلال. قال لأنه من ناحية السرف. والله أعلم.
وفيه جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنّة إلا كرعنا». قال: والرجل يحوّل الماء في حائطه. فقال. يا رسول الله، عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثمّ شرب الرجل الذي جاء معه. وترجم لحديث جابر: باب الكرع في الحوض. وفيه: فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة. قلت: رضي الله عنك! شرب اللبن بالماء، هو أصل في نفسه. وليس من باب الخليطين في شيء.
فيه عائشة: كان النبي- صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. والحلواء كل شيء حلو. قلت: رضي الله عنك! ترجم على شيء وأعقبه بضده. وبضدّها تتبين الأشياء. يشير إلى أن الطيبات هي الحلال لا الخبائث. والحلو من الطيبّات وأشار بقول ابن مسعود إلى أن كون الشيء شفاءً ينافي كونه حراماً والعسل شفاء فوجب أن يكون حلالاً. ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة نصّا. ونبّه بقوله: شرب الحلواء أنهّا ليست الحلواء المعهودة التي يتعاطاها المترفون. وإنما هي شيء حلو يشرب: إما عسل بماء أو غير ذلك مما يشاكله.
قلت: رضي الله عنك! الحديث مطابق للترجمة. والتيامن وإن كان مستحباً في كل شيء إلا أن المنقول عن مالك أنّ البداءة في الماء خاصة. فلعلّ البخاري احترز من هذا فخصّ الترجمة بالشرب موافقة للواقعة. والقياس أن مناولة الطعام أيضاً كذلك. وملتحق به كل ما يقسم على هذا الوجه مطلقا.
قلت: رضي الله عنك! لم يستغن بالترجمة التي قبلها، وهي قوله: باب اختناث الأسقية وعدل عنها لاحتمال أن يظن أن النهي عن صورة اختناثها. فبيّن بالترجمة الثانية أن النص مطلق فيما يختنث وفيما لا يختنث كالفخار، مثلاً.
قلت: رضي الله عنك! أورد الشارح سؤال التعارض بين هذا الحديث وبين النهي عن التنفس في الإناء. وهو الحديث المتقدم على هذه الترجمة. وأجاب بالجمع بينهما. ولقد أغنى البخاري عن ذلك فإنه ترجم على الأولى: باب التنفس في الإناء فجعل الإناء ظرفاً للتنفس، وهو المنهي عنه. وجعل الشرب مقروناً بنفسين أي لا يشرب بنفس واحد خوف الربو، بل يفصل بين الشربين بنفس أو أكثر.
قلت: رضي الله عنك! مقصوده- والله أعلم- أن شرب البركة يغتفر فيه الإكثار لا كالشرب المعتاد الذي ورد أن يجعل له الثلث لقوله: وجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه.
فيه ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها...» الحديث. قلت: رضي الله عنك! عبّر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيمانه كلها أنها قابلة للتحلّل بالكفارة. وإنمّا تكفر اليمين بالله تعالى خاصة. فدخل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف إلا بالله فيخرج الحلف بالآباء. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قلت: رضي الله عنك! مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] لأن لا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف مطلقاً مرتكب للنهي. فبيّن أن اليمين لمثل هذا القصد الصحيح مشروعة. والقصد تأكيد الكراهة عندهم للتختم بالذهب.
فيه ثابت بن الضحاك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير ملة الإسلام، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذّب به في نار جهنم. ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله». قلت: رضي الله عنك! قصد بهذه الترجمة وبما أعقبها من حديث (الحلف باللات) أن يبيّن أن قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير ملة الإسلام، فهو كما قال». ليس على ظاهره في نسبته إلى الكفر، بل هو كما قال في كذبه مثل كذب المعظم للات من الجهة العامة إذا حلف بها.
قال: لا تقسم فيه البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. وفيه أسامة: أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلينا أن ابني قد احتضر. فأشهدنا وقمنا معه. الحديث. وفيه أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم». وفيه حارثة بن وهب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعّف، لو أقسم على الله لأبّره. وأهل النار كل خوّاض عتلّ متكبر». قلت: رضي الله عنك! مقصوده من هذا الباب- والله أعلم- الردّ على من لم يجعل القسم بصيغة أقسم يميناً منعقدة كالشافعي وكمالك في قوله بأنها ليست يميناً حتى تذكر معها اسم الله، أو ينوي. فذكر البخاري الآية. وقد قرن القسم فيها بالله. ثم بيّن أنّ هذا الاقتران ليس شرطاً بالأحاديث، فإنه جعل هذه الصيغة بمجردّها يميناً تتصف بالبرّ من غير الحالف، وهو المحلوف عليه.
فيه أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزّة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزّتك ويزوى بعضها إلى بعض». قلت: رضي الله عنك! مقصود الترجمة أن الحلف بالصفات القديمة بصيغة المصدر كالحلف بالأسماء. وطابقت الترجمة قوله: أعوذ بعزتك, مع أن هذا دعاء وليس بقسم من ناحية أن لا يستعاذ إلا بالقديم. فأثبت هذا أن العزة من الصفات القديمة، لأن من صفة الفعل فتنعقد اليمين. والله أعلم.
فيه أبو هريرة: يرفعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم». وفيه عبد الله بن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل، فقال: كنت أحسب كذا. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، كنت أحسب كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «افعل ولا حرج». الحديث. وفيه ابن عباس مثله. وفيه أبو هريرة: إن رجلاً دخل المسجد يصلي- والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد- فجاء فسلّم عليه. فقال: «ارجع فصل فانك لم تصل». فقال في الثالثة: علّمني. فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء. ثم استقبل القبلة وكبّر واقرأ بما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». وفيه عائشة: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيها. فصرخ إبليس أي عباد الله! أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. فنظر حذيفة: فإذا هو بأبيه. فقال: أبي أبي، فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم! فقال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. وفيه أبو هريرة: من أكل ناسياً وهو صائم فليتّم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فيه ابن بحينة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس. ثم رفع ثم كبّر وسجد. ثم رفع رأسه ثم سلّم. وفيه ابن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فزاد ونقص منها فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذلك. قال: فسجد بهم ثم قال: «هاتان السجدتان لمن لم يدر زاد في صلاته أو نقص فيتحّرى الصواب فليتّم ما بقى ثم يسجد سجدتين». وفيه أبي بن كعب: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً} [الكهف: 73] قال: كانت الأولى من موسى نسياناً. وفيه البراء: كان عندهم ضيف فأمر أهلهم أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم. فذبحوا قبل الصلاة. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يعيد الذبح. وفيه جندب: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد، ثم خطب فقال: «من ذبح فليعد مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله». قلت: رضي الله عنك! لما كان حكم الناسي قاعدة مختلفاً فيها، وكذلك الجاهل هل يلحق بالناسي أو العامد؟ أطال البخاري الأحاديث المتعارضة فيه. فمنها ما قام النسيان فيه عذراً مطلقاً. ومنها ما كان الخطأ فيه ملغى، وألحق صاحبه بالتعمد. ومنها ما عذر به من وجه دون وجه. والتدبر يبيّن ذلك. والله أعلم.
وفيه عائشة: حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله. وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه. فقال: والله لا أنفق على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله سبحانه: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى} [النور: 22]. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. وفيه أبو موسى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملته فحلف أن لا يحملنا. ثم قال: «والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها». قلت: رضي الله عنك! حديث أبي موسى يطابق اليمين فيما لا يملك. قال الشارح. لأنه لم يكن يملك ظهراً يحملهم عليه. فلما طرأ الملك حملهم. وفهم عن البخاري أنه نحا ناحية تعليق الطلاق قبل ملك العصمة، أو الحرّية قبل ملك الرقبة. والظاهر من قصد البخاري غير هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملهم، فلما حملهم وراجعوه في يمينه. قال: «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم». فبيّن أن يمينه إنما انعقدت فيما يملكه، لأنهم سألوه أن يحملهم. وإنما سألوه ظناً أنه يملك حملانا فحلف لا يحملهم على شيء يملكه لعدم الملك حينئذً. كأنّه قال عليه السلام: والله ما أملكت حملانا فكيف أحملكم؟ والذي حملكم عليه مال الله لا ملكه الخاص. فلو حملهم على ما يملكه لكفّر. ولا خلاف فيها إذا حلف على شيء وليس في ملكه أنه لا يفعل فعلاً متعلقاً بذلك الشيء مثل قوله: والله لا ركبت هذا البعير ولم يكن في ملكه. ولو ملكه وركبه حنث وكفّر. وليس هذا من تعليق العتق على الملك. والله أعلم.
فيه أنس: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخذت خماراً لها، فلفّت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس- الحديث- فأتت بالخبز فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقت وعصرت عكة لها، فأدمته ثم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول. الحديث. قلت: رضي الله عنك! مقصوده أن يرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذا كان اصطبغ فذكر حديث عائشة. والمعلوم أنها نفت الإدام مطلقاً في سياق وبيان شظف العيش فدخل فيه التمر وغيره. وحديث أنس إنها عصرت العكة. على الأقراص فلم يكن اصطباغ، قال: فأدمته.
وفيه أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته. لكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدّرته. فيستخرج إليه به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل». قلت: رضي الله عنك! موضع الاستشهاد قوله: «يستخرج به من البخيل» ما يجب عليه، لا ما هو متبّرع به، وإلا كان جوداً.
وفيه أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لغنيّ عن تعذيب هذا نفسه».- ورآه يمشي بين ابنيه-. وفيه ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. وقال: يقود إنساناً بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ثم أمره أن يقود بيده. وقال ابن عباس مرة: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجلٍ قائم فسأله عنه فقال: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مره فليتكلم، ويستظل، وليقعد وليتّم صومه». قلت: رضي الله عنك! نفى الشارح ترجمته هاهنا على النذر فيما لا يملك، وقال: لا مدخل له في هذه الأحاديث، وإنما يدخل فيها نذر المعصية. والصواب مع البخاري، فإنه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك نذر المتصرف في ملك الغير، وهو معصية. فمن هاهنا أدخله في الترجمة. والله أعلم. ولهذا لم يقل: باب النذر في ما لا يملك، وفي المعصية ولكنه قال: «النذر فيما لا يملك». ثم قال: «ولا نذر في معصية»، اندرج النذر في ملك الغير في النذر في المعصية الذي نفاه عن العموم فتأمله.
|